الرسومات مهداة من الفنان مصطفى رحمة
كانت الساعة تقترب من العاشرة مساء عندما أقبلت نحو زنزانتنا أصوات أقدام فى أحذية ثقيلة، لم يكن السكون قد ساد العنبر بعد، إذ تتواصل المسامرات والنداءات المتبادلة بين السجناء عبر قضبان «الهوَّايات» الصغيرة بأعلى أبواب الزنزانات، ومع بروز أصوات الأقدام المقتربة من زنزانتنا فى طرقة العنبر عم الصمت. كانت أصوات الأقدام فى الأحذية الثقيلة تعنى أن بوابة العنبر قد فُتحت لأمر طارئ وعاجل ويستدعى إجراءات مشددة.
اتضحت صلصلة حلقة مفاتيح الزنزانات خارج زنزانتنا فاستدارت وجوهنا نحن الأربعة نحو بابها. تبادلنا نظرات التساؤل والريبة، ووقفنا مشدودين بقرب الباب. دار المفتاح المعدنى الكبير فى الكالون، وأسفر انفتاح الباب الأسود الثقيل عن ظهور شاويش العنبر برفقة اثنين من عساكر السجن. وقال الشاويش يحادثنى بصوت عالٍ ونبرة متعجلة: «جهز نفسك بسرعة يادُكتُر حالة مستعجلة فى سجن الحريم!».
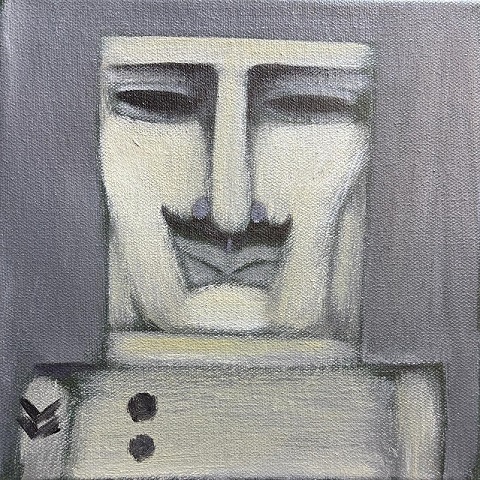
سجن الحريم؟! الحريم؟! انشدهت وجوه رفقاء الزنزانة الثلاثة ــ مصطفى وهبة وثروت أبو سعدة وعادل عبدالباقى ــ بينما يحدقون فى وجهى بدهشة، واستثارة، وغبطة، و.. حسد! نعم حسد، فها هو واحد منهم سيذهب إلى الجنة المفقودة، صحيح أنه ذاهب ليرى مريضة فى زنزانة، وربما يكون مرضها مما يحزن ويؤلم، لكنه سيرى غيرها من السجينات المعافيات، واللائى ربما يجد بينهن جميلات، أو غير جميلات، فيكفى أنهن إناث. وياللأنوثة التى لا يُعرف قسوة الحرمان بتغييبها عن عالم الرجال قدر المسجونين.
كنا أربعة فى الزنزانة، ثلاثة منا طلاب جامعة غير متزوجين، أما الرابع الذى يكبرنا بعشر سنوات، فقد كان مُدرِّسًا متزوجًا وأبا لابنتين. صحيح أنه كانت لكل من ثلاثتنا بدايات حب أو أطياف حب، إلا أن السجن بأسواره وقضبان بواباته ونوافذه وعالمه الذكورى، كان يُعرِّى مدى هشاشتنا البشرية كذكور فى عالم بلا إناث. وكان أقسى معاناة دواخلنا هى الشوق إلى الأنثى، كوجود حانٍ ومُعطِّر ومُلطِّف وندى ومُدفئ، وبغيابه يصير الوجود فى عالم السجن أقسى وأخشن وأجف وأبرد. لهذا لم يكن غريبا أن جانبا كبيرا وعميقا من مسامرات سهرنا مكرَّس لاستحضار قصص حبنا أو حب أصدقائنا، بل سيرة الأنوثة فى وعينا ولا وعينا.
أحاديثنا عن الإناث كانت تستحضر وجودهن أطيافا فى أخيلتنا وعواصف فى مشاعرنا وصرخات بلا صوت تناديهن. لكن المُعادِل لكل هذه الاستحضارات لدينا كشبان وطلاب جامعة وسجناء سياسيين، كان لدى السجناء الجنائيين إجراءات عملية مكلفة، أو عالية المخاطرة، تساوى الحياة كلها أحيانا، لمجرد أن يرى السجين منهم أنثاه، أو أى أنثى، خاصة السجناء الذين طالت بهم سنوات الحبس.
كنت مرتبكا وأنا أدور حول نفسى واقفًا وسط الزنزانة وحولى زملاء الحبسة، بينما يتعجلنى الشاويش مُشخشخًا بحلقة المفاتيح. قلت «دقايق ألبس هدومى» إذ كنت أقف على «البورش» حافيًا وفى بيجامة النوم، لكن الشاويش اعترض نافخًا «لا يا دُكتُر.. إنت تيجى كده، البت هاتموت لو اتأخرنا عليها»، وهنا قفز «الروب ديشمبر» لينقذ الموقف، ويمنحنى لمحة من وقار الطبيب يُخفى ابتذال أن يعود مريضًا بل مريضة، وهو فى بيجامة! وهذا الروب ديشمبر كان حكاية من طرائف حبستنا، بل لمحة من العودة إلى طفولة ما، تستحوذ على البشر إذ يصيرون سجناء.
هذا «الروب ديشمبر» كان لا يخص أيًا من أربعة زنزانتنا الذين رسا عليهم الاتهام فى قضية انتفاضة يناير 1977 فى المنصورة، بل هو لوالد زميلنا إيمان يحيى الذى كان ضمن عشرات مَن قُبِض عليهم فى أعقاب يومى الانتفاضة، وخرج بعد شهر تقريبًا. ولأن سجننا بدأ فى ذروة برودة الشتاء أرسل الأب هذا الروب لابنه حتى يتدثر به فى برد السجن الذى كان قارصا حقا. وقد ترك إيمان ذلك الروب الصوفى الأنيق لنا على أن نرده ما إن تخف البرودة.

الروب ديشمبر كان بالنسبة لنا «أبهة» أكثر من كونه رداءً للدفء، فرُحنا نتبادله عندما يفتحون الزنزانات للخروج إلى الحوش وقت الفسحة، ويمشى لابسه واضعًا يديه فى دفء جيبى الروب مربوط الحزام، مشعا بتباهٍ دفين وسط السجناء الذين تلفت أنظارهم هذه الأبهة. وبمنطق «العدالة الاجتماعية» التى كنا نرفع نداءها، وضعنا جدولًا ليحظى كل منا بدور من الدفء والوجاهة داخل هذا الروب. ولم يكن الروب من دورى فى ذلك الليل الذى جاءنى فيه ذلك النداء شبه الخيالى لأكشف على أنثى فى سجن الحريم.
لا أتذكر أى زملاء الزنزانة كان يرتدى الروب فى هذا الوقت، لكننى أتذكر روعة اللحظة التى تنازل بها لابس الروب عن دفئه وأبهته لأرتديه، وكان زملائى لا يساعدوننى فقط فى ارتدائه وربط حزامه وهندمة ياقته، بل تحولوا إلى مساعدين يجهزوننى بأدوات الطبيب وبعض أدوية الطوارئ التى أحملها معى وأنا أغادر «عيادتى» فى الزنزانة الخالية المجاورة فى الساعة الثالثة عصرًا، وقت انتهاء «الفسحة» وبدء غلق الزنزانات.
استقرت السماعة وجهاز الضغط فى الجيب الأيمن للروب مع لمسة ظاهرة تشى بوجودهما، وفى الجيب الأيسر بعض أدوية الطوارئ، أما الجيب الصغير على الصدر فقد استقر به خافض اللسان وميزان الحرارة و«تورش» إضاءة طبى. تم كل ذلك بسرعة، ولم يكن فى هذا التسريع وقت لارتداء حذائى، فخرجت فى الشبشب. وودعنى زملائى وعيونهم تغبطنى على منحة زيارتى للفردوس المفقود! بينما ملامحهم المشدوهة تومئ لى: «ها تحكيلنا.. هه.. ها تحكيلنا؟!».
●●●
«ماذا أحكى»؟.. ذهبت ومكثت فى هذه المهمة حوالى ساعة، وعدت إلى زنزانتنا دون الروب ديشمير، واجمًا شاردًا شرود الصدمة، فسجن النساء الذى كان يخايلنا عبر النوافذ الخلفية لزنزانات صفنا، والذى تبدَّى لنا ولغيرنا من النزلاء كحرملك يزخر بالإناث، بستان متعة من رفيف الحوريات وهبات الهوى المتقد. أخيلة كان يعززها فى سجن الرجال ليس شقاء الافتقاد للإناث فقط، بل تؤججها إغراءات الإناث المرئية والمسموعة عبر قضبان نوافذ زنزاناتهن المواجهة ــ على مد البصر ــ لنوافذ زنزانات الرجال، بعد انتهاء «الفسحة» والدخول إلى الزنزانات وإغلاقها.
عادة، وفى الوقت من بعد العصر وحتى ما قبل الغروب، تظل تتطاير عبر قضبان الزنزانات نداءات الرغبة الصريحة والمستترة ما بين الجانبين، ففى الفضاء الذى يصعب تكبيله بين السجنين يتجلى العرض الإيروسى من وراء القضبان. يُفتتَح بصوت أنثى تنادى: «يا واد يا واد.. يا واد يا اللِّى باحبه»، ويرد على صوت الأنثى صوت ذكر من سجن الرجال وبالصيغة نفسها «يا واد يا واد.. يا واد يااللِّى باحبه»، ثم تنطلق المجاهرة «بت يا بطة» وترد بطة «واد يا عربى»، وتدوى المجاهرات بأسماء نسائية وأسماء ذكورية غير معروف إن كانت أسماء حقيقية أم مُدَّعاة. ثم يبدأ التحقق: «شايف إيدى يا واد» وتخرج من بين القضبان يد أنثى تُلعِّب أصابعها، ويرد الواد «شايفها يابت.. شايفة إيدى أنا؟». ويتصاعد الشوف..
فجأة، وعبر تداخل الأصوات بين الجانبين، تدوى زنزانات سجن الرجال بصيحة جماعية جنونية: «هاااااااااه»، فثمة واحدة من سجن النساء عرَّت صدرها ودفعت بنهدها عبر أحد مربعات قضبان نافذة زنزانتها مدلِّلة تنادى «الحلو آهو.. آهو أهو..» فيجيب صوت رجل زاعق بالتياث «قشطااااه قشطاااااه»، وترد الأنثى مربتة على نهدها: «ما لكش فى الطيب نصيب يا واد»، وتتوالى أطياف النهود النافرة من بين القضبان، فيُجَن الرجال الذين عادوا أولادًا «هااااااااااه» صيحة جماعية داوية، لاتعرف إن كانت آهة استوحاش أم استهوال أم كليهما!
يبدو الفضاء بين السجنين كأنما يشتعل بهياج الأصوات، ويوشك على تأجيج حريق انفعالى يصعب إطفاؤه، وتتدخل الإدارة بسرعة لقمع جنون هذا الصخب. تنسحب هاربة مع الصراخ نهود الإناث المطلة من مربعات مابين قضبان نوافذ زنزاناتهن، وتنطلق احتجاجات الذكور: «الله ع المفترى.. الله ع المفترى»، إذ يتردد أن سَجَّانات سجن الحريم عند هذه الذروة، يفتحن زنزانات نوافذ «القشطة» وقد فككن «قوايش» الجلد السميك التى تُحزِّم وسطهن، ويهوين بها جالِدات صدور نجمات ذروة العرض، فتتصاعد صرخات فزعهن والألم، كما نقيق دجاجات بوغتن بهجمة ثعالب ضارية.
وعلى عكس ما تنتهى عروض المسارح والسينمات بإيقاد الأضواء، تنتهى عروض ما وراء القضبان بالإظلام، تنطفئ الأصوات، ويبدأ الأفق إعتامه قرب الغروب. غروب ساكت موحش، أكأب غروب، ذلك الذى يُشاهَد من وراء القضبان زاحفا يمهد لظلمة ليل السجون، وكوابيس نوم السجون. ولعل هذا ما جعلنى خفيفًا مغتبطًا بدعوة تلك الليلة لمناظرة الألم! ففى ثنايا ألم مريضة سجينة كان هناك وعد منحة نادرة.. ندرة إطلال شاب يحس أن داخله كاتبا ينمو بالتجارب، مُرَّة كانت أو حلوة!
أمر واحد كان يقلقنى ويشوش اغتباطى بمنحة هذه التجربة.. إنه امتحانى الطبى فيما أنا ذاهب إليه بسجن النساء، كنت فى السنة النهائية على وشك التخرج، وكان نفورى من الدراسة النظرية فى المراحل الأولى بالكلية قد تحول إلى شغف وجدية فى المرحلة الإكلينيكية، لم أترك فيها جلسة نقاش سريرى على المرضى فى المستشفى إلا وحضَّرت له وحضرته، وصرت أذاكر بحماس، بل بفرح. لهذا بدا دخولى السجن قُبيل امتحان التخرج بشهور قليلة كنقمة، سرعان ما تحولت إلى نعمة.. أعفتنى من تشتت تعدد الانشغالات، فصارت كتب الطب متعتى وشاغلى، ووجدت نفسى أسعد بالاجتهاد فى معالجة مرضى العنبر، حال عدم وجود طبيب السجن، الذى لا يتواجد إلا فى الصباح.
بات الوقت أمامى صافيًا ورحيبًا، ويبدو أننى سجلت نجاحا ما لفت انتباه إدارة السجن، فمنحتنى - وديًا - زنزانة خالية مجاورة لزنزانة أربعتنا، وضعت فيها كتبى وأدواتى الطبية وبعض الأدوية. أقضى فيها وقت فتح الزنزانات، أذاكر وأستقبل المرضى، فصارت هذه الزنزانة عيادة العنبر، وأنا الطبيب! بل وصل الأمر بهذه العيادة وبى، أن خُصِّص لى سجين يعاوننى كتومرجى «واد فهيِّم وحِرك ونضايفى»، على حد تعبير شاويش العنبر، وقد كان «سمير» كذلك بالفعل، برغم أنه بحرفته وقضية سجنه: «نشَّال!».
كان كل ذلك طريفًا، ويحيل سجنى إلى تجربة ممتعة! لكن أن أُستدعَى إلى حالة طارئة فى الليل، وبسجن النساء، فهذا كثيرَ، وخطير أيضًا إن فشلت طبيًا فى التعامل مع الحالة التى سأواجهها. وظل ذلك يناوشنى بعد أن تهيأت للذهاب صحبة الشاويش ومرافقَيه، وصارت خطوات الأحذية الثقيلة فى أقدام ثلاثتهم على بلاط ردهة العنبر بينما نمضى للخروج.. كأنها دق الطبول فى رأسى، ودوى طلقات فى وحشة الصمت. لكن.. ما إن اجتزنا بوابة العنبر حتى شعرت بسكينة مُهدهِدة إذ داعبنى نسيم الليل فى الفناء الخالى.
●●●
فى الطريق إلى سجن النساء، كانت تنتابنى لمسة إحساس بلطف الوجود، فالليل الساجى بدا لى شفيفًا متلطفًا وأنا أمضى عبر استثناء أرفل فيه، وتثمل خطواتى بنشوة مُدفئة بعدما انفتحت بوابة سجننا الرهيبة لأخرج مُبجَّلا وإن محروسا. يمضى موكبى الصغير فى ممشى ترابى يحف بمزرعة السجن حتى نصل إلى بوابة سجن الحريم. بوابة أخرى سوداء عالية مصفحة، تنصبُّ عليها أضواء كشافات ساطعة تُعشى البصر. يدق الشاويش تصفيح هذه البوابة بكعب مفتاح معدنى كبير، فيخفق قلبى بين فضول ووجل. ثم تنفتح كوة بالبوابة تطل منها أجزاء من وجه امرأة تبدو خشنة متفرسة. قلَّبت عينيها الثقيلتين فى ثلاثتنا وقالت «اتأخرتوا ليه»، ثم فتحت بابا صغيرا خفيضا فى البوابة الكبيرة، وأشارت لى أن أدخل، دخلت، وأغلقَت الباب خلفى.
كانت المرأة برتبة «باش شاويش» خمسينية ضخمة، حدجتنى بنظرة مُتشككة، وهى تدون فى دفتر البوبة اسمى ووضعى، ثم استدارت ونادت بصوت مرتفع اسما حضرت على أثره سجانة أصغر سنا ورتبة، قادتنى عبر طرقات شحيحة الضوء وصعدت بى درجا حديديا، ثم مضت أمامى فى ردهة طويلة تتابعت على يسارها أبواب زنزانات مغلقة، وفى نهاية الردهة كانت هناك زنزانة بابها مفتوح ويُلقى بشريط من ضوء كابٍ على بلاط الردهة. ومع التقدم نحو الزنزانة المفتوحة أخذ سعال يائس يتضح أكثر فأكثر حتى صار ذابحا، وما أن وقفت على باب هذه الزنزانة حتى جمدت لثانية أو ثانيتين كانتا دهرا داخلى، ففى الضوء الأصفر المُقبِض للمبة الزنزانة باغتنى هول الدم.
دٌم أحمر قانٍ، دمٌ شريانى لابُد كان يشكل بطرطشته شبه دائرة على طلاء ظهر الزنزانة الأبيض الجيرى تحت النافذة متقاطعة القضبان، وفى شبه تلك الدائرة تمركزت السجينة التى تنطلق سعلاتها الذابحة قاذفة بالدم من فمها، بينما اثنتان من زميلاتها المسجونات تسندان ظهرها إلى الجدار الدامى. كانت شابة ضئيلة صادمة الشحوب، يغطى الدم فمها وذقنها وعنقها وصدر جلبابها الدمور الأبيض.
مرق فى ذهنى مصطلح «هيموبتِسس» «نفث الدم» كعرض يعنى خروج نفثات الدم من الفم، لكنها فيما كنت أراه لم تكن مجرد نفثات بل دفقات مخيفة من الدم تطلقها سعلاتها. ركعت على ركبتى بجوارها لأبدأ الكشف عليها، وكنت قد تأقلمت مع هذا الوضع العسير وأنا أكشف على المرضى فى زنزانة «عيادتى» كما فى الزنزانات التى أُستدعَى للكشف على مريض فيها، فزنزانات السجون العمومية ليست بها أسرة، بل مجرد «أبراش» سميكة من الليف تغطى الأرض الأسمنتية، وتُفرَد عليها بطانيات قديمة كأماكن للنوم وللجلوس.
طلبت من زميلَتَى المريضتين أن تكشفا صدرها ففعلتا برغم أن الدم كان يبلل ثيابها ويغرق أيديهما. وكدت أبكى لرؤية ثديى المريضة إذ بَدَوَا كفرخين منكمشين تحت هطل مطر قارس، ثديا فتاة لم يُطفئ فقر الدم الصارخ فى شحوبهما نضارة الحلمتين الصغيرتين، ظلتا ورديتين لم تغمقا! أومأت برأسى مغلقًا عينى أتسمع ما ينبغى سماعه وراء ضلوعها الرقيقة، فلم أعثر على دقات قلبها التى غطتها فرقعات السعال وحشرجات التنفس، فنحيت سماعتى ورفعت رأسى فاتحا عينيَّ على وجهها. أولتنى نظرة اخترقت روحى، كانت نظرة امتنان كسير، تشكر مجيئى وتهون علىَّ بما توحى به نظرة واهنة تهمس «لا تتعب نفسك.. أنا أموت».
نظرة عينين واسعتين بجمال أسيان.. عينان تبدوان غائرتين وسط هالتين داكنتين تُجلِّيان شحوب وجهها. نظرة استبْقتها ذاكرتى من عمر الثامنة عشرة لصبية فقيرة كانت مصابة بالسل وتعرف أنها ستموت صغيرة، كانت شديدة الرقة وعلى قدر من الحسن الكسير والأنوثة الشفافة، وبالتأكيد كانت تهفو لأن تُحِب وتُحَب، واستغل هشاشتها تلك أحد سفلة ذلك العمر. كان لعوبًا كذوبًا، ألقى شباكه على المسكينة فاستسلمت له وصار يستهلكها بعد أن يغطى وجهها حتى لا تعديه! بل كان يعزم أصحابه عليها! وقد دفعنى فضول الشعر الذى كنت أكتبه لمشاهدة هذه المخلوقة.
لم أرَ فيها إلا بنُيَّة صغيرة الجسم شفافة بوجه جميل شاحب وبعينيها صفاءٌ استثنائى ورقرقة كسيرة. فجَّرت داخلى ينبوعًا من الأسى والتعاطف وربما الحب! حب إنسانى شفيف ونظيف كان يحملنى للقائها، ومعى هدايا صغيرة تفرح بها لحد رقرقرقة عينيها الواسعتين بالدمع. وقد منحتنى «للذكرى» من صنع يديها وشاحًا صوفيًا رقيقًا فيروزى اللون، مشغولًا بزهور ملونة منمنمة، علَّقته بالعرض أعلى باب غرفتى الصغيرة بعد موتها حتى أنحنى وينحنى كل من يدخل الغرفة لتلك المخلوقة التى رحلت بالسل فى عمر الزهور.

السل نفسه الذى عرفته أيضًا فى وجهى امرأتين شابتين فنانتى سيرك جوال يجوب القرى المحيطة بالمنصورة، انضممت إليه كلاعب أكروبات أرضية ودورات على عقلة متنقلة عندما قصدنى رجل الفرقة ولاعبها الوحيد إذ تعرض لإصابة تعيقه عن أداء دوره فى هذا السيرك. مكثت أقوم بهذا الدور متطوعًا ثم شغوفًا حتى دخلت كلية الطب، وإن لم أنقطع عن زيارة بيتهما الجُحر، مسكن غريب من غرفتين فى بدروم ليس به نوافذ، رطب ومعتم دائمًا، وعرفت متأخرًا أن المرأتين الشابتين أُدخلتا مستشفى الصدر كمريضتى سل، ثم رحلتا. ثلاثة وجوه للسل استدعاها وجه السجينة التى تسعل دمًا.
لحيرتى وقلة حيلتى حيال سل رئوى جارف النزيف، لم يسعنى إلا التوصية بأن تظل المريضة فى وضع نصف جالسة ومائلة قليلًا إلى الأمام حتى لا يتراكم الدم فى مجرى الهواء فتختنق. وركعت على ركبتىّ لأشرح لزميلتيها ذلك. وكنت وأنا أتكلم أرنو إلى وجه المريضة مربتًا على كتفها النحيل الهش مُهدِّئا، فتلتفت إلىّ شاكرة النظرات برقرقة وجهها الشاحب وعينيها كسيرتى الرجاء، ترجونى ألا أتعب نفسى فهى تعرف أنها تموت!
نهضت من ركوعى بينما دوار الأسى واليأس يلفنى، ووجدتنى أستعيد مشهد نزيف السل الرئوى الحاد الأخير الذى أنهى حياة كاتبى الأحب أنطون تشيخوف، فالطبيب الذى استدعوه على عجل، لم يكن بوسعه ووسع الطب حينها إلا أن يوصى بمادة أفيونية مهدئة للسعال النازف، وعمل كمادات من الثلج على صدره لإحداث انقباض انعكاسى للأوعية الدموية يقلل النزيف. لكن تشيخوف بخبرة الطبيب، وبحدس الفنان العظيم، أدرك أن ذلك لا يُجدى، فراح يبتسم لزوجته بعطف، وهى تحاول إعطاءه الدواء، وهمس مرددًا: «إننى أموت.. إننى أموت»، كأنه يرجوها ألا تتعب نفسها! تمامًا كما رجتنى نظرات السجينة النازفة. فهل أتركها تموت؟ ساءلت نفسى بلوم وتقريع، فوجدتنى أصارع انفجارى!
●●●
ما إن ابتعدت عن تلك الزنزانة الأليمة بما يكفى حتى انفجرت، قلت للسجانة التى رافقتنى إلى بوابة الخروج بأن تبلغ الإدارة بأن المريضة ستموت الليلة إذا لم تُنقَل على عجل للمستشفى، وإذا ماتت فسأشهد بقتلها نتيجة الإهمال. كنت منفعلًا أتكلم محركًا يدىّ أمامى فانتبهت أن يدىّ مغطاتان بالدم، كما أن كُمَّى الروب وصدره مغطاة أيضًا بالدم، ففزعت.
طلبت بإلحاح أن أغتسل، فأرشدتنى السجانة إلى حمام السجينات الذى يخلو فى الليل، وهناك غسلت يدىّ بعنف، وخلعت الديشمبر وطويته، بحيث يكون صدره الملطخ بدم المريضة وطرفا كميه فى مركز تكوُّر لففت عليه البقية الجافة من قماش الروب. وفيما أخذت أجفف يدىّ فى جوانب بنطلون البيجاما منحنيًا، شممت رائحة مقبضة غريبة ليست مما هو معهود فى دورات المياه، تلفَتُّ باحثًا عن مصدر تلك الرائحة فواجهت دمًا آخر، دمًا يلوث خرقًا ومناديل ورقية ومزقًا من قماش ثياب أنثوية مزقتها صاحباتها السجينات الفقيرات لستر دوراتهن الشهرية.
وستُلفت نظرى هذه الرائحة نفسها بعد ذلك بسنتين، عندما عملت نائبًا فى أحدث وأنظف مصحات الأمراض النفسية بالثغر، ففى أول مناوبة ليلية لى، فوجئت بتلك الرائحة مع أولى خطواتى فى عنبر للمريضات، تساءلت؟! فعرفت أن الأمر ليس نقص فوط صحية، فهى توزع مجانًا على النزيلات حال احتياجهن لها. ولكن لأن عديدا من مريضات «الذهان» أى «الجنون» ــ بترجمة عارية - يمكثن بما نزفنه غير منتبهات حتى تنتبه الممرضات والعاملات، ويكون الأمر متأخرًا، وبتعدد وتراكم ذلك تتحول الرائحة المقبضة إلى أثر مقيم.
ويا لها من كناية بليغة الإيلام لمسخ طبيعة «ربات النظافة»، الإناث، الإناث إذ ينتهين إلى زنزانات السجون وعنابر الجنون! فالأنثى التى هى مخلوق مفطور على النظافة والتنظيف بقدَر الأمومة وغريزة الرعاية، عندما تُسجَن، أو تُجَن.. تصير أمثولة أليمة لغياب النظافة. إنها رائحة سحق الأنوثة. ولعلها استعارة أكبر عن أمثولة الدم عندما يغادر دورة الحياة إلى ركود الموات، وكذلك الأمم فى رِبقة الطغاة.
●●●
عدت من سجن الحريم منقبضًا منطفئًا إلى عنبر زنزانتنا خافت الإضاءة فى عمق الليل، وفى يدى كرة الديشمبر المطوية على دم السجينة الشابة المشحون بعُصيَّات بكتيريا السل، وعندما توقفنا أمام باب زنزانتنا، وهم الشاويش بفتح بابها خرجت من غيمة الانقباض التى تلبثتنى، فالكرة التى أحملها بحذر تحمل إمكانية عدوى السل لى ولزملائى فى الزنزانة. وضعت كرة السل تلك إلى جوار الباب، فسألنى الشاويش لماذا أرمى هذا «البالطو»؟ فشرحت له الأمر، ليقول لى: «دا غسلة جامدة بميه بتغلى فيها صودا تموِّت أى حاجة وحشة». سألته أين أفعل هذا؟ فرد بتساؤل مُستغرِب: «وليه انت اللى تعمل ده؟!»، ورشح لى من مساجين الشغل بالمغسلة «الوله هادى»! ولم يكن هادى هذا ولدًا بل سجينًا خمسينيًا من مساكين السجن، محنى الظهر لانثنائه الطويل على ما يغسله فى حوض من أحواض المغسلة. واكتسب اسم «هادى»، لأنه يمضى شتاءً وصيفًا فى فانلة داخلية مشمرًا بنطلونه عن قدميه الحافيتين المبتلتين دائمًا، يردد «يا هادى.. يا هادى». وهو حكاية داخل حكاية مما عرفته فى «عيادتى» الزنزانة!
